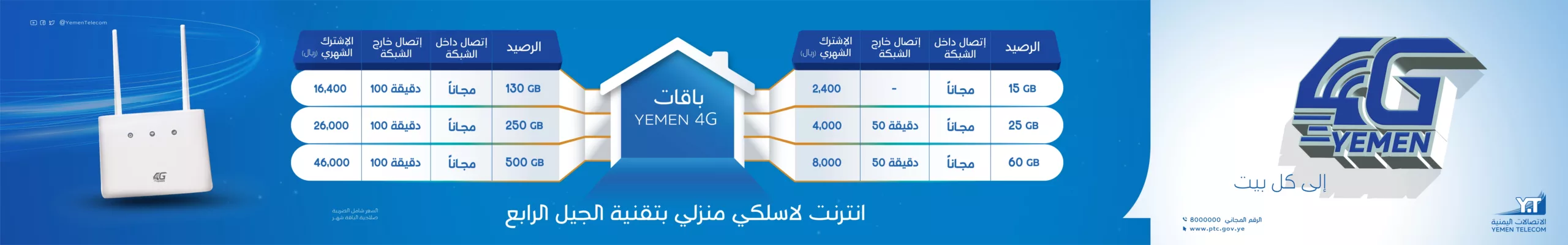رغم ما يُروّج له بعض الخطاب الرسمي والتاريخي من أن الوجود العثماني في العالم العربي كان امتدادًا للخلافة الإسلامية ووحدة الأمة، إلا أن قراءة موضوعية لتاريخ العلاقة بين العثمانيين والعرب تكشف أن السلطنة العثمانية مارست، وعلى مدى قرون، سياسة “فرّق تسد” بكل أدواتها الناعمة والخشنة، بهدف الإبقاء على العرب في حالة انقسام وضعف دائم، تُسهّل السيطرة عليهم وتمنع تشكّل أي كيان سياسي موحد يمثلهم أو ينافس سلطان الباب العالي.
منذ دخولهم الساحة العربية، اعتمد العثمانيون على التحالفات القبلية المتناقضة، فغالبًا ما كانوا يفضلون دعم قبيلة أو زعامة محلية ضد أخرى، في محاولة لكسر التوازنات الداخلية وتعطيل نشوء مركز موحد للقرار المحلي. هذا الأسلوب عمّق النزاعات، وزرع بذور الفتن، وأدخل المجتمعات العربية في دوامات من الحروب الأهلية والاستنزاف، ضمنت للعثمانيين استمرار الحاجة إلى تدخلهم “كوسيط”، فيما كانوا هم الفاعل الحقيقي في تكريس الانقسام.
وسعى العثمانيون إلى استغلال التنوع الديني والمذهبي في المشرق العربي، فوظّفوا الانقسام بين السنة والشيعة، والمسلمين والمسيحيين، بما يخدم توازناتهم السلطوية. وتم توظيف الزعامات الروحية وتوجيهها وفق مصالح الباب العالي، حيث مُنحت امتيازات لطوائف معينة مقابل الولاء السياسي، وهو ما حوّل الطائفية إلى أداة من أدوات الحكم، وأفرغ المجتمعات من أي مشروع وطني جامع.
ولم تكن هذه السيطرة مقتصرة على التوجيه العام، بل تجسّدت أيضًا في السياسات الإدارية، حيث عمدت الدولة العثمانية إلى تقسيم الأراضي العربية إلى ولايات وإيالات صغيرة، خاضعة لوكلاء الباب العالي، دون أي اعتبار لوحدة جغرافية أو قومية أو اقتصادية. ففُرض على العرب نظام إداري عقيم، منع تشكّل كيان سياسي عربي جامع، وجعل من كل ولاية وحدة منفصلة، تابعة إداريًا وعسكريًا لإسطنبول، ومحروسة بأجهزة التجسس العثمانية، التي استخدمت الدين في الظاهر، والإكراه السياسي في الباطن.
وفي الوقت نفسه، تم استقطاب نخب محلية ومنحها امتيازات شكلية، في حين جرى تهميش القيادات القومية الحقيقية. فصارت النخبة التي تتحدث باسم العرب في كثير من الأحيان، مجرّد طبقة وسيطة تخدم السلطان لا الشعب، وتعيش على الامتيازات لا على قاعدة وطنية، مما كرّس التبعية، وعمّق الفجوة بين المجتمعات العربية والنظام الحاكم.
ومع بدايات القرن العشرين، بدأت بوادر التململ العربي تتصاعد، خاصة بعد أن تكشفت خيوط التحالف بين العثمانيين وجماعات تغريبية داخلية، فاندلعت حركات المقاومة في الحجاز والشام والعراق، وسُحقت بيد من حديد، وتم شنق العشرات من المفكرين والقادة العرب في ساحات دمشق وبيروت بأوامر مباشرة من جمال باشا السفّاح، أحد أبرز رموز حزب الاتحاد والترقي المتحالف مع الدونمة والماسونية.
إضافة إلى تلك السياسات الرعناء، تحالفت السلطنة العثمانية مع الغرب في مواجهة العالم العربي، وكان من نتائج تلك التحالفات أن تخلت إسطنبول عن أراضٍ عربية لصالح الاستعمار الغربي، أولها الجزائر التي دخلتها فرنسا عام 1930م دون أي أي مقاومة عثمانية رغم أنها ولاية من ولايات الباب العالي، والأمر نفسه تكرر في مصر عام 1882م، حيث قبلت الدولة العثمانية الاحتلال الانجليزي مقابل استمرار دفع الضرائب والاعتراف الاسمي بسلطانها، ما منح الإنجليز غطاءً شرعيًا لتثبيت وجودهم لعقود، وأضفى على الاحتلال مسحة “شرعية” استخدمها للترويج لنفسه في الداخل والخارج.
في المقابل، كانت قيادة السلطنة آنذاك مخترقة من قبل تنظيم “الاتحاد والترقي”، وهو تحالف يضم عناصر من يهود الدونمة والماسونيين، وكان يحرّك قرارات الدولة بما يخدم مشروعها الطوراني، لا المشروع الإسلامي. وقد غضّت هذه القيادة الطرف عن التحركات البريطانية والفرنسية في الشام والعراق واليمن، بل استخدمت القوة المفرطة ضد الحركات العربية، كما فعل جمال باشا في الشام، في الوقت الذي كانت فيه تل أبيب تُزرع، وباريس ولندن تتقاسمان المنطقة.
ـــــــــــــــــــــــــــ
محمد محسن الجوهري